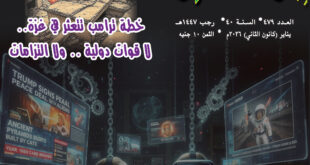المدرسة المصرية: وقد احتلت مركز القيادة بين المدارس المالكية بزعامة ابن القاسم أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة (191هـ)، واعتمدتها مدرسة إفريقية والأندلس اعتمادًا كليًّا، كما كانت سماعات ومرويات ابن عبد الحكم عن مالك، وهو أبو القاسم عبد الرحمن ابن عبد الله بن عبد الحكم مؤرخ من أهل العلم بالحديث….
د. محمد الإدريسي الحسني
بقية: رجاله وعصره وآثارهم
بقية: المدخل:
المنهج النقدي وأثره في تطور المذهب المالكي:
يعتبر أبو الحسن علي بن زياد الطرابلسي المولد والنشأة، ثم التونسي نشاطًا ودعوة، (ت 183هـ)، هو مؤسس المدرسة الفقهية المغاربية عامة، والقيروانية على وجه الخصوص، بأجلى مظاهرها، والتي لا تزال مزدهرة إلى يومنا هذا، ممتدة الفروع ثابتة الأصول، فبجهوده تركز المذهب المالكي في هذه الديار، فهو الذي شيد هذا الصرح العلمي العظيم الباقي على مر الأيام، رغم العوارض والكوارث والمناوئين من الكائدين مثلما يتعرض له المذهب من هجمة جاهلية هذه الأيام، هذه المدرسة التي وضع لبنتها علي بن زياد الطرابلسي، هي مدرسة مالك بن أنس، فهو الذي أدخل مذهبه إلى كل الديار المغاربية، وعرّف به، وشرحه للناس، وبيّن قواعده حتى اقتنعت به الأفكار، ولم يجتذبها إليه بسلطان ولا نفوذ، وفي هذا المجال التأسيسي تميز رجلان أثرًا على الأفكار تأثيرًا لم يكن لأحد، أبو الحسن علي بن زياد الطرابلسي، وأبو محمد يحيى بن يحيى بن كثير الليثي (ت 234هـ)، وهو كذلك إمام وفقيه تميز بالأندلس، وهو صاحب واحدة من أشهر روايات الموطأ، أخذها عنه أهل المشرق والمغرب، وكان شيخ المالكية في الأندلس في زمانه، وإن كان متأخرًا في الطبقة عن ابن زياد، إلا أنه كان له من المكانة ما جعله معدودًا في التأسيس مثله.
برز من بين من تتلمذوا على يد شيخ الإسلام ابن زياد، الإمام أبو عبد الله أسد بن الفرات بن سنان (ت 213هـ)، وقد تميز بشغف شديد للعلم وعزيمة قوية في طلبه، فأراد الاستزادة فرحل إلى المدينة حيث سمع من مالك، ثم رحل إلى العراق ودرس على أبي يوسف القاضي، وهو يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري المشهور بـأبي يوسف وهو من تلاميذ الإمام أبي حنيفة النعمان (ت 183هـ)، ولازم مدة طويلة محمد بن الحسن الشيباني (ت 189 هـ) وهو عالم وفقيه ومحدث ولغوي، صاحب الإمام أبي حنيفة النعمان، وناشر مذهبه، حتى إذا أدرك من مذهبهما بغيته عاد إلى مصر بعد وفاة مالك، فعرض على ابن القاسم مشروعًا علميًّا نقديًّا رائدًا، بأن يجيب على اختيارات أبي حنيفة ومذهبه، بما سمعه من مالك أو بما يراه إن تعذر السماع، فظهر أول كتاب فقهي في المذهب بعد الموطأ سماه أسد باسم (الأسدية)، جمعت بين المنهج العراقي في تفصيل المسائل، وطبق عليها منهجًا نقديًّا وفق أسس المذهب المالكي في مسائل الأحكام، ذلك الكتاب القيم الذي تلقفه أبو سعيد عبد السلام سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي (ت 240هـ)، وأخضعه لمنهج نقدي تعلمه من أسد بن الفرات، فلاحظ في الأسدية آراء تخالف ما عليه المنهج المالكي وفتيا فقهاء المالكية، فرجع بها إلى ابن القاسم، أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة (ت 191 هـ)، وهو أهم تلاميذ الإمام مالك، وأكثرهم ملازمة له واخلاصًا لمنهجه الفقهي، صحب الإمام مالكًا عشرين عامًا، اقترح سحنون على ابن القاسم، إعادة النظر في الأسدية، بالنقد والتصحيح والترجيح، وبذلك رد سحنون الفقه المالكي إلى طريقته المدنية الأولى فقهًا ومنهجًا، مع الحفاظ على ما أفاده أسد من منهج أهل العراق.
وبهذا الثلاثي (أسد وابن القاسم وسحنون): ظهر أكثر الكتب اعتمادًا في المذهب، وأصبح ابن القاسم وسحنون حجري الزاوية في المذهب، ولذلك قيل: إنهما مهندسا المذهب، وفي المقابل فقد أثرت المدرسة المصرية في العراقية من خلال مؤلفات ابن عبد الحكم، فقد روى الأبهري العراقي في ترتيب المدارك (6/186) (سمع ابن عبد الحكم المصري وقرأ مختصره خمسمائة مرة والأسدية خمسًا وسبعين مرة). وأثرت كذلك في المدرسة الأندلسية حيث أضحى قول ابن القاسم هو الذي يحكم به في محاكم قرطبة كما في كتاب نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب لمؤلفه أحمد ابن محمد المقري التلمساني (ص 4/202)، بل ما خالفوا رأي ابن القاسم إلا في ثماني عشرة مسألة فقط، مخالفين رأي مالك في أربع مسائل فقط كما بينه دكتور محمد ابراهيم علي في كتابه (اصطلاح المذهب المالكي ص88). وقد أحدث هذا المنهج نقلة نوعية عظيمة أثرت المكتبة الفقهية المالكية، بأمهات لا زال أثرها مشعًّا بين طلبة العلم الشرعي الصحيح. سنشرع بإذن الله في تناولها.
قواعد الفتوى عند فقهاء المذهب المالكي:
بمتابعة الرصيد التراكمي للمنهج الذي سار عليه فقهاء المالكية، يتأكد تعدد الروايات المروية عن الإمام مالك في المسألة الواحدة، كما تعددت الأقوال الاجتهادية لتلاميذه الذين عاصروه، ولأئمة المذهب من بعدهم، ما أدى إلى تضخم الخلاف الاجتهادي، فبات من الضروري ضبط هذا الخلاف وُفق معايير علمية، تحدد قوة الروايات والأقوال التي ترجح رؤية أحد المختلفين عن الآخر، لترجيح أصحها، عند الحكم والفتوى، ليكون معتمدًا يؤخذ به عند الاختلاف، لذلك كثيرًا ما نقرأ جملة: اتفاق أهل المذهب، أو إجماع العلماء، أو ما عليه الجمهور. ويقصد بهذا ما وافق قول الأئمة الأربعة، إذا كانت المسألة تناقش خلافًا عامًّا، أما إذا كان الخلاف فقط بين فقهاء المذهب فالمقصود بالجمهور جل الرواة عن الإمام مالك أو ما عليه جل فقهاء المالكية.
وقد نظم النابغة الغلاوي، وهو محمد النابغة بن عبد الرحمن بن أعمر بن بنيوك السلاوي الشنقيطي، (ت 1245هـ)، صاحب «نظم بُوطْلَيْحِيَّة»، وهو نظم يتكون من 314 بيتًا على بحر الرجز يتناول فيه المعتمد من الكتب والفتوى على مذهب المالكية، ويستعرض مجموعة من المسائل الفقهية، والموضوعات الأصولية، والصوفية، والعقدية. وقال في متنه مبينًا ما به الفتوى:
فما به الفتوى تجوز المتفق
عـليه فالراجح سـوقـه نـفق
فبعده المشهور فالـمساوي
إن عدم الترجيح في التساوي
أي أن ما به الفتوى في المذهب المالكي: المتفق عليه، فإن لم يوجد، فالراجح، ثم بالقول المشهور، فإن لم يوجد يفتى بأحد القولين المتساويين.
 مجلة الإسلام وطن موقع مشيخة الطريقة العزمية
مجلة الإسلام وطن موقع مشيخة الطريقة العزمية